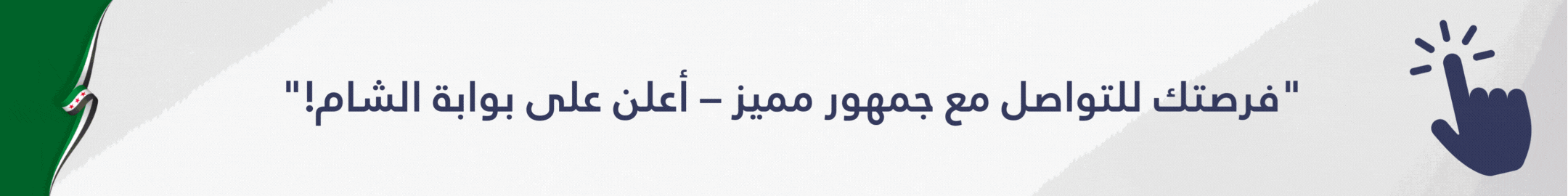الجلاد أمام الضحية.. هل تنتهي القصة أم تبدأ؟

علي سفر
لقاء السجين بالسجان، بعد انتهاء محنته، وبعد تغير الأحوال، واحدة من أكثر اللحظات إثارة في السياق الإبداعي، حيث استُدعيت كثيرًا في الأعمال الروائية والقصصية وكذلك في السينما والمسرح، ورغم أن هذا التفصيل يحتاج إلى عرض للنماذج التي صنعت شيئًا كهذا، إلا أن معظم ما اشتهر كان ينتهي بانفضاض اللحظة، وترك السجان السابق يلقى مصيره في الحياة مع ورم أخلاقي قد يسرطن روحه!
لكن هل يمكن للحياة أن تفرز واقعًا كهذا حقًا؟ حدثت في الواقع السوري، وبحسب اطلاعي، لحظتان سابقتان لسقوط النظام: الأولى حين التقى المحامي أنور البني في ألمانيا صدفة بضابط المخابرات العقيد أنور رسلان وقرر أن يقاضيه بسبب تاريخه وأفعاله قبل الانشقاق عن النظام، وانتهى به الحال لأن يتلقى حكمًا بالسجن المؤبد.
وقبل هذا تحدث الكاتب محمد برو، صاحب كتاب “ناج من المقصلة”، عن لقائه مع سجانه في تدمر بشكل عابر، ولم يحدث شيء مهم في هذه اللحظة سوى الأثر الذي انطبع في عقله عن قدرة الاستبداد على سلب الجلادين إنسانيتهم، ثم معاودتهم للحياة الرثة بشكل طبيعي خارج حيز المعتقل الرهيب.
الحرية لدى السوريين لم تكن مرتبطة بكون الواحد منهم قابعًا في السجن أو متروكًا خارجه، بل كانت ربما هي ذلك الأمل بأن يخرج خارج الحدود أو أن يسترد المولى جل وعلا أمانته!
غير أنه منذ سقوط النظام الإجرامي الدموي، صار لكل سوري لحظته الخاصة، فبعد تفكك السور الحديدي للتسلط والقمع والإرهاب، صار المجموع الخائف في العقود السابقة أكثر شجاعة في مطاردة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين كلهم، ودون التفريق بين السوري المقيد في المعتقلات الكبرى وفي مهاجع وزنازين الأفرع الأمنية، وبين السوري الآخر الذي لم تستهدفه الأجهزة وتركته يتهتك إنسانيًا في السجن الكبير!
الحرية لدى السوريين لم تكن مرتبطة بكون الواحد منهم قابعًا في السجن أو متروكًا خارجه، بل كانت ربما هي ذلك الأمل بأن يخرج خارج الحدود أو أن يسترد المولى جل وعلا أمانته! هذا الاستسلام للقدر صار اليوم جزءًا من الماضي، وبات على الضحايا أن يصنعوا مشهدًا مختلفًا، قوامه أن يطاردوا أدوات القمع والترويع من ضباط وعناصر وشبيحة وغير ذلك ليضعوا القيود في أيديهم وأن ينتظروا مسار المحاسبة! البعض، وقد اتسع جرحه ونزف طويلًا، لا يقبل بأن ينتظر، ولهذا يلجأ للاقتصاص من ظالميه، وقد حدث هذا كثيرًا طوال الشهور الماضية، لكن أثره لم يكن في الواقع، ومن يقتل جلاده يرضي نزعة الانتقام لكنه يترك القصة التي تحتوي العبرة من دون نهاية ذات أثر، ومثلما بدأت حكايته في العتمة، سيجري فعل القتل في العتمة وربما تحت الضوء!
لكن كيف يمكن لفكرة القصاص أن تؤدي مفعولها من دون أن تكون واضحة ومفهومة لدى الآخرين؟! وبحسب قراءة حيثيات كل واقعة من هذا النوع سيصبح الحدث أشبه بمطاردة بوليسية قد يهرب المجرم فيها من ضحاياه، في حال فشل المطاردون في مهمتهم، وطالما أن ثمة احتمالًا للجلاد أن ينجو، فهذا يعني أن احتمالات معاودته لأفعاله تبقى كبيرة!
ينطوي مفهوم العدالة الانتقالية على بُعد نفسي مهم جدًا لإرضاء الذوات المتأذية، فهي تهدف في جوهرها إلى معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتحقيق نوع من الإنصاف والمصالحة المجتمعية، لكن الإرضاء ليس عملية سهلة أو موحدة، لأن تطلعاتهم متنوعة وتتراوح بين العقاب الصارم، والاعتراف بالمعاناة، وضمان عدم تكرار الجريمة، وصولًا إلى التعويض أو رد الاعتبار. لتحقيق ذلك، يمكن للعدالة الانتقالية أن ترضي الضحايا عبر مسارات متكاملة، مثل المساءلة والمحاسبة، والاعتراف بالحقيقة، والتعويض وجبر الضرر، وضمان الذاكرة وعدم التكرار!
ليست مواجهة الضحية مع جلاده نهاية الحكاية، بل بدايتها الحقيقية؛ فإما أن تصير جسرًا نحو عدالة تعيد للروح كرامتها، أو تظل ندبة مفتوحة في ذاكرة وطن يبحث عن شفاء.
ضمن مفاعيل المفهوم في الواقع، يجد الضحايا وبشكل نظري الاهتمام الكبير بما عانوه ووقع عليهم، ولكن هذا لا يحدث دون أن تمتد يد مؤسسات إنفاذ القانون نحو المجرمين، فتسجنهم ولا تتركهم يسرحون ويمرحون أمام العيون! وإذا لم تكن آليات تقديم الشكاوى وإثبات الجرائم بأدلة قاطعة واضحة ومفهومة للجمهور والمتضررين على وجه الدقة، فإن العمل كله سيكون ضبابيًا وغير مفهوم!
ما فعلته وزارة العدل قبل أيام حين عرضت للحظات من التحقيق مع أربعة من المتهمين الكبار في دعم وتنفيذ سياسات النظام، وكذلك ما صرحت به وزارة الداخلية عن اعتقالها لعدد من سجاني سجن صيدنايا، وإتاحتها للقاء عدد من الضحايا بسجانيهم، يقودنا دائمًا للتفكير بالمصائر الشخصية لهؤلاء الذين جعلوا حيوات الآخرين جحيمًا، فالموقف هنا ليس مادة للتأمل في اللحظة الدرامية فحسب، بل هو أيضًا تأمل في المعنى الإنساني لمفهوم العقاب، والتركيز على عدم الإفلات منه! وإذا قُيض لهذا المسار أن يكتمل، فإن البلاغة المنتظرة منه تتأتى من خلال محاسبة كل إجرام حدث في مفاصل الحياة السورية، أي أن على كل من شارك في تيسير عمل الأجهزة القمعية التي سفكت الدماء والأرواح أن يُحاسب، حتى وإن احتاج الأمر لعقود من الزمن، فمثلما جرى على السوريين وقع على آخرين، والقصص التي نُقلت من تجارب الشعوب كثيرة، وتمنح الأمل بأن العدالة ستطال الآثمين.
ليست مواجهة الضحية مع جلاده نهاية الحكاية، بل بدايتها الحقيقية؛ فإما أن تصير جسرًا نحو عدالة تعيد للروح كرامتها، أو تظل ندبة مفتوحة في ذاكرة وطن يبحث عن شفاء. وحين تُرفع القيود عن الأيدي، يجب أن تُرفع أولًا عن القلوب، لتكتمل القصة بمعنى الحرية لا بثقل الانتقام.